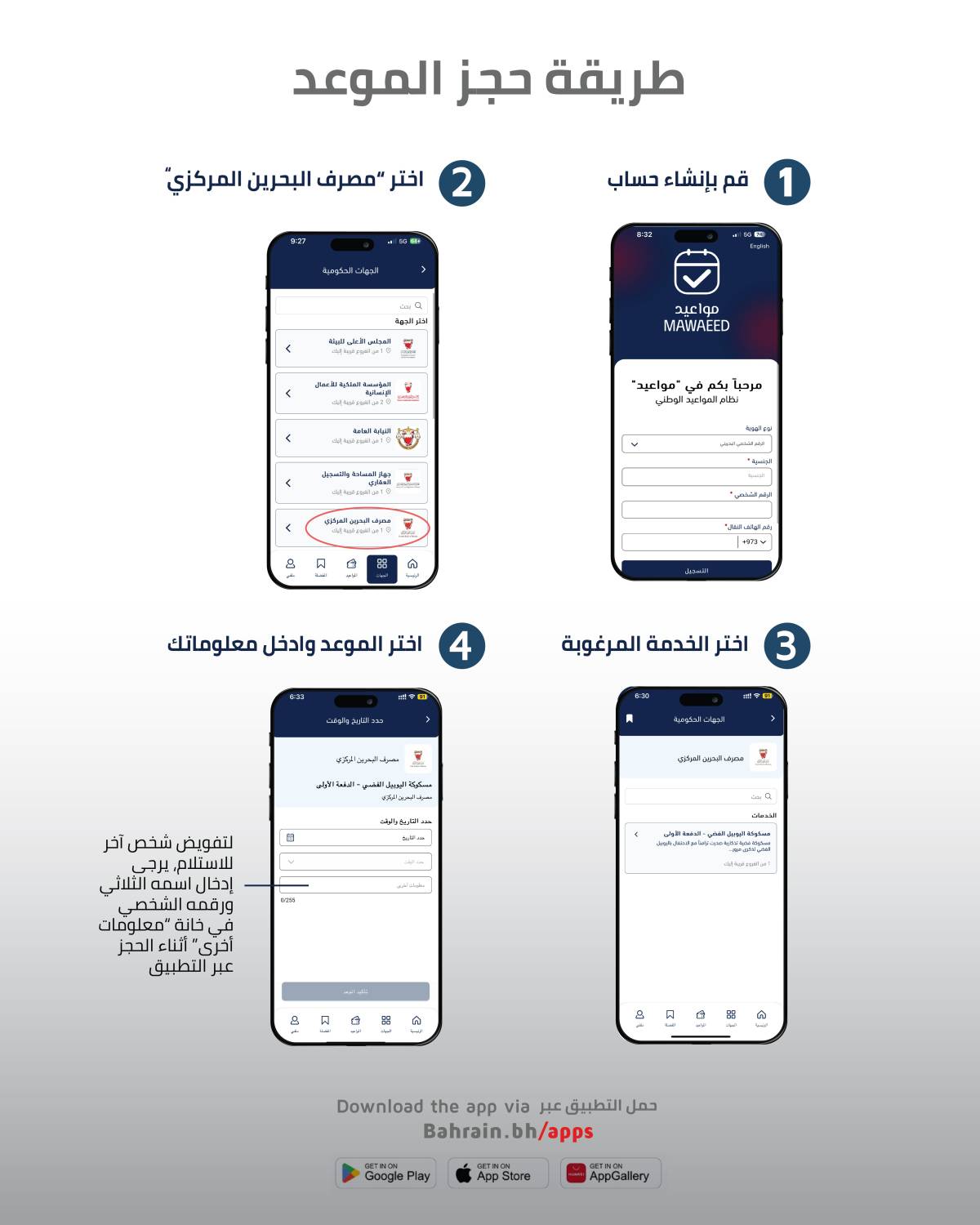سألني أستاذنا الكبير يحيى حقي، عندما التقيت به أخيراً في إحدى المناسبات، عما إذا كنت أذكر النقد الذي وجهه إلى روايتي الأولى (تلك الرائحة) عقب نشرها أول مرة في فبراير 1966. وعندما أجبت بالإيجاب سألني عن رأيي الآن، بعد مرور عشرين سنة، في نقده، وفي روايتي عموما.
في تلك اللحظة كنت قد أوشكت أن أنسى كثيراً من تفاصيل الرواية. فقد مرت سنوات طويلة منذ قرأتها لآخر مرة. فليس من عادتي أن أعود إلى ما سبق لي كتابته. فمثل هذه القراءة تثير مللي، إن لم تكن مصدراً للشعور بالإحباط. أما النقد الذي وجهه الأستاذ يحيي حقي للرواية، فلم أنسه أبداً!.
كنت قد دفعت بالمخطوطة إلى مطبعة بدائية صغيرة في حي الظاهر، في فترة نادرة من تاريخ مصر الحديث ألغيت فيه الأحكام العرفية. ولم يعد الكتاب يتطلب موافقة الرقابة قبل دخول المطبعة. رسميا على الأقل! فلقد احتفظ الرقيب بمكتبه ووظيفته كما كان الأمر في السابق. وكل ما حدث من تغيير هو أن مكتبه أصبح بلا لافتة وأن مصادرة الكتب لم تعد تتم قبل الطبع وإنما بعده.
وهذا ما حدث مع كتابي فلم تكد طباعته تنتهي حتى صدر الأمر بمصادرته. ولا أذكر إذا كنت قد استدعيت إلى مكتب رئيس الرقابة أو أني ذهبت بنفسي شاكياً. المهم أني قابلت المرحوم طلعت خالد، أحمد معاوني عبدالقادر حاتم المخلصين. وكان قد جمع لديه كبار موظفي مصلحة الاستعلامات ليتسلوا بالفرجة علي. وبسط أمامه نسخة من الرواية المصادرة، وقد ظهر أثر القلم الأحمر على هامش أغلب صفحاتها. ثم سألني باستهزاء: لماذا رفض البطل أن ينام مع المومس التي أحضرها صديقة. هل هو "مرخي"؟
لم أعنَ كثيراً بمجادلته. وكنت قد تمكنت من استخلاص عدد من النسخ المصادرة، فقمت بتوزيعها على أصدقائي ومعارفي من الكتاب والصحفيين. وحاولت أن أوسط البعض منهم من ذوي النفوذ في الإفراج عن الرواية. فذهبت مع المرحوم الأستاذ زكي مراد إلى الأستاذ أحمد حمروش، الذي كان يرأس تحرير مجلة "روز اليوسف" في ذلك الوقت. ورحب الرجل بي بحرارة، وأراني بروفة العدد الجديد من المجلة وبه تعليق صغير له عن الرواية تحت عنوان "لغة العصر". وعندما أبلغته بنبأ المصادرة ظهرت عليه البغتة، ورفع سماعة التلفون واتصل بقريبه الأستاذ حمدي حافظ في مصلحة الاستعلامات، فاستمع إليه برهة، ودون أن يعيد السماعة إلى مكانها اتصل بمطبعة المجلة وطلب شطب مقاله عن الرواية.