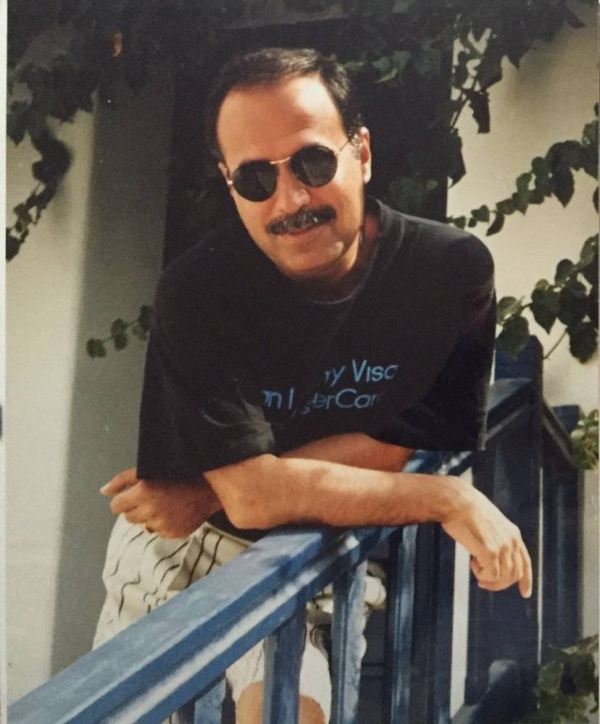والداي نزحا إلى شرقي السعودية بحثاً عن معيشة أفضل بعد ظهور النفط نصيحة غازي القصيبي جعلتني أغادر بوسطنحسن الستري، تصوير: نايف صالحارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بتراجم كثير من الشخصيات المؤثرة عبر مؤلفاته وأعمدته الصحفية التي تناول فيها التوثيق لكثير من الشخصيات التي عاصرت حقبة تاريخية مهمة في منطقة الخليج، ورغم تخصصه في العلاقات الدولية والشأن الآسيوي إلا أنه ترك بصمة واضحة على مر السنوات الماضية في ترجمة الكثير من الشخصيات سواء عبر مؤلفاته وأعماله الصحفية إنه الكاتب والباحث الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية والشأن الآسيوي الدكتور عبدالله المدني الذي تعرج الوطن معه في حوار شامل على محطات مهمة في سيرته ومسيرته.إذا سألتك كيف تصف نفسك؟ فماذا تقول؟- أنا مجرد مواطن بحريني خليجي محب لوطنه وللخليج العربي، أنتمي إلى الجيل الذهبي الذي ولد مع انتصاف القرن العشرين واكتمل وعيه مع نهايات الخمسينات الميلادية، وهو الجيل الذي عاصر أحداثاً وتحولات ومتغيرات كثيرة أثرت في ثقافته وفكره وتجاربه، وشهد مرحلة التنمية المبكرة بعد اكتشاف النفط، وعاش مرحلة الطفرة النفطية التي زلزلت منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة بكل تأثيراتها الإيجابية والسلبية.وقد حباه الله قدراً من العلم والمعرفة فحاول ولا يزال يحاول إيصاله إلى الآخرين من خلال الكتابة والنشر والبحث والتقصي.حدثنا عن بدايتك، الميلاد والنشأة الأولى وسنوات الطفولة- ولدت بمدينة الخبر مع انتصاف القرن العشرين ابنا أكبر لوالدي اللذين نزحا إلى شرق السعودية بحثا عن معيشة أفضل مثل الكثيرين من البحرينيين الذين فعلوا الشيء نفسه بعد أن سمعوا عن ظهور النفط في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وما نجم عن الحدث من انتعاش الأحوال الاقتصادية والمعيشية، حيث سكن والدي وقتذاك في منزل صديقه محمد ناصر الدوسري على سيف البحر وسط الحي التجاري القديم في مدينة الخبر. في هذا البيت أبصرت النور وعشت السنوات الأولى من طفولتي، حينما كان والدي يتلمس طريقه في التجارة من بعد محاولات فاشلة في الطواشة ثم في العمل كأجير يومي لدى شركة أرامكو. وقتها افتتح والدي دكاناً بشارع الملك سعود لبيع خليط من السلع غير المتجانسة كحال معظم دكاكين تلك الفترة، فكان يبيع مثلاً الأقمشة والملابس والأحذية وزيوت الشعر والأجهزة الكهربائية والأسرة الحديدية وصناديق التجوري والتتن والفحم والمصابيح وأسلاك الكهرباء والمراوح، وكان معظمها يشتريه من البحرين بالدين من تجار معروفين مثل فخرو والغربللي والجامع وكاجريا والقصيبي ويتيم وغيرهم وينقلها على ظهر المراكب الشراعية إلى فرضة الخبر. وقد حقق الوالد مع مرور الوقت نجاحاً في تجارته بسبب الطلب المتعاظم على شراء بضائعه، وخصوصاً أن الخبر وقتذاك كانت تعج بالقادمين من مختلف المناطق للعمل في منشآت أرامكو النفطية بعد أن اتخذت منها أرامكو مركزاً لتوفير مختلف الخدمات لموظفيها الأجانب.
 هل كانت هناك جالية بحرينية كبيرة في الخبر آنذاك؟ وفي ماذا تركزت أنشطتهم؟- لم تكن الخبر غريبة على البحرينيين، ليس بسبب قربها الجغرافي من أرخبيل البحرين فقط، وإنما أيضاً لأن أول من بناها وسكنها هم دواسر البحرين. لذا كانت تعج بالعائلات البحرينية والتجار البحرينيين الذين ساهموا بمالهم وخبرتهم في توفير مختلف أنواع السلع والخدمات المطلوبة. وبقدر ما ساهموا فقد استفادوا، حيث نجد بينهم من لمع تجارياً واقتصادياً بسبب فورة الأنشطة والأعمال هناك، ونجد بينهم من قدم خدمات عن طريق العمل في المصارف الناشئة ووكالات السفر والسياحة والفنادق والمطاعم والجمارك وغيرها. وعليه تستطيع القول إني نشأت في بيئة بحرينية خارج البحرين، وخصوصاً مع وجود مكان أثير كان يجتمع فيه معظم البحرينيين المقيمين أو العابرين يومياً للسهر والطرب والنقاش والترفيه والطبخ هو منزل التاجر المرحوم إبراهيم عبدالرحمن الجناحي الذي كان محله التجاري عنواناً يستخدمه البحرينيون لتلقي رسائلهم وحاجاتهم المرسلة من فرضة المنامة.هل عشت طفولة سعيدة؟- كانت طفولتي بصورة عامة سعيدة، إذ لم يكن ينقصني شيء من الضروريات، وخصوصاً بعد أن أنعم الله على والدي بخيراته ومكنه من بناء بيت عربي حديث مستقل بوسط الخبر وتأثيثه بكل اللوازم. غير أني بسبب كوني الابن الأكبر لأبوين أميين، ثم بسبب عدم وجود أعمام وأخوال يقطنون معنا أو بجوارنا فقد عانيت من عدم وجود من يساعدني ويوجهني في بعض الواجبات المدرسية، الأمر الذي جعلني أعتمد كلياً على نفسي في فك طلاسم المقررات. كذلك اعتمدت على نفسي في تلبية احتياجاتي الكمالية من ملابس وكتب ومجلات، عن طريق الادخار من مصروفي المدرسي الضئيل. فعلى سبيل المثال كنت أقتصد كل يوم بضعة قروش، حتى إذا صارت عشرين قرشاً «أي ريال سعودي واحد» مع نهاية الأسبوع انطلقت إلى أقرب مكتبة تجارية لشراء نسخة من إحدى مجلتين مصريتين: «المصور» أو «الكواكب». ومازلت أحتفظ بتلك المجلات إلى اليوم وأحاول ترميمها بعد أن فتك بها تقادم الزمن، لأني ارتشفت منها ثقافتي الأولى وعرفت منها ما كان يدور في العالم من أحداث ساخنة في سن مبكرة.
هل كانت هناك جالية بحرينية كبيرة في الخبر آنذاك؟ وفي ماذا تركزت أنشطتهم؟- لم تكن الخبر غريبة على البحرينيين، ليس بسبب قربها الجغرافي من أرخبيل البحرين فقط، وإنما أيضاً لأن أول من بناها وسكنها هم دواسر البحرين. لذا كانت تعج بالعائلات البحرينية والتجار البحرينيين الذين ساهموا بمالهم وخبرتهم في توفير مختلف أنواع السلع والخدمات المطلوبة. وبقدر ما ساهموا فقد استفادوا، حيث نجد بينهم من لمع تجارياً واقتصادياً بسبب فورة الأنشطة والأعمال هناك، ونجد بينهم من قدم خدمات عن طريق العمل في المصارف الناشئة ووكالات السفر والسياحة والفنادق والمطاعم والجمارك وغيرها. وعليه تستطيع القول إني نشأت في بيئة بحرينية خارج البحرين، وخصوصاً مع وجود مكان أثير كان يجتمع فيه معظم البحرينيين المقيمين أو العابرين يومياً للسهر والطرب والنقاش والترفيه والطبخ هو منزل التاجر المرحوم إبراهيم عبدالرحمن الجناحي الذي كان محله التجاري عنواناً يستخدمه البحرينيون لتلقي رسائلهم وحاجاتهم المرسلة من فرضة المنامة.هل عشت طفولة سعيدة؟- كانت طفولتي بصورة عامة سعيدة، إذ لم يكن ينقصني شيء من الضروريات، وخصوصاً بعد أن أنعم الله على والدي بخيراته ومكنه من بناء بيت عربي حديث مستقل بوسط الخبر وتأثيثه بكل اللوازم. غير أني بسبب كوني الابن الأكبر لأبوين أميين، ثم بسبب عدم وجود أعمام وأخوال يقطنون معنا أو بجوارنا فقد عانيت من عدم وجود من يساعدني ويوجهني في بعض الواجبات المدرسية، الأمر الذي جعلني أعتمد كلياً على نفسي في فك طلاسم المقررات. كذلك اعتمدت على نفسي في تلبية احتياجاتي الكمالية من ملابس وكتب ومجلات، عن طريق الادخار من مصروفي المدرسي الضئيل. فعلى سبيل المثال كنت أقتصد كل يوم بضعة قروش، حتى إذا صارت عشرين قرشاً «أي ريال سعودي واحد» مع نهاية الأسبوع انطلقت إلى أقرب مكتبة تجارية لشراء نسخة من إحدى مجلتين مصريتين: «المصور» أو «الكواكب». ومازلت أحتفظ بتلك المجلات إلى اليوم وأحاول ترميمها بعد أن فتك بها تقادم الزمن، لأني ارتشفت منها ثقافتي الأولى وعرفت منها ما كان يدور في العالم من أحداث ساخنة في سن مبكرة.
 وهل كانت دراستك النظامية بالسعودية؟- نعم لقد كنت محظوظاً، لأنني من الطلبة الذين درسوا مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بالمدارس التي بنتها شركة أرامكو بمدينة الخبر وتولت وزارة المعارف السعودية إدارتها. إذ كانت هذه المدارس تشبه الكليات الجامعية في الغرب لجهة التصميم الهندسي والمساحات الشاسعة الملحقة والأثاث المريح والأجهزة والأدوات المدرسية الحديثة والأنشطة المتنوعة، ناهيك عن أطقم معلميها الذين كانوا يحملون الدرجات الجامعية والعليا من رعايا الأردن والسودان والعراق ولبنان وإنجلترا وجنوب إفريقيا وأستراليا والهند. أضف إلى ذلك أن تلك المدارس كانت تدرس مواد إضافية خارج نطاق المقررات الرسمية من أجل تنمية ثقافة الطالب والارتقاء بحسه الفني وتعليمه مهنا يستفيد منها ماديا خلال عطلة المدارس الصيفية مثل الطباعة على الآلة الكاتبة التي كانت مطلوبة كثيرا في تلك الفترة من قبل البنوك والشركات. ولا أبالغ لو قلت أني عشت أجمل سنوات طفولتي وصباي في تلك الأجواء واستفدت منها كثيراً. أما المرحلة الثانوية فقد درستها في المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة بالخبر من عام 1967 إلى 1970 لعدم وجود ثانوية من بناء شركة أرامكو. وفي هذه المدرسة كانت الأجواء مختلفة وكنا نفتقد أشياء كثيرة تعودنا عليها، لكننا صبرنا وتكيفنا مع مرور الوقت، وخصوصاً مع سعادتنا بتعلم اللغة الفرنسية ضمن المنهج الرسمي على أيدي مدرسين من تونس. وأتذكر أني صممت وحررت آنذاك أول صحيفة حائط مدرسية باللغة الفرنسية التي عشقتها وواصلت تعلمها سنوات وأصبحت أجيدها إلى جانب العربية والإنجليزية والفارسية والهندية وشيء من الألمانية واليونانية والفنلندية.
وهل كانت دراستك النظامية بالسعودية؟- نعم لقد كنت محظوظاً، لأنني من الطلبة الذين درسوا مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بالمدارس التي بنتها شركة أرامكو بمدينة الخبر وتولت وزارة المعارف السعودية إدارتها. إذ كانت هذه المدارس تشبه الكليات الجامعية في الغرب لجهة التصميم الهندسي والمساحات الشاسعة الملحقة والأثاث المريح والأجهزة والأدوات المدرسية الحديثة والأنشطة المتنوعة، ناهيك عن أطقم معلميها الذين كانوا يحملون الدرجات الجامعية والعليا من رعايا الأردن والسودان والعراق ولبنان وإنجلترا وجنوب إفريقيا وأستراليا والهند. أضف إلى ذلك أن تلك المدارس كانت تدرس مواد إضافية خارج نطاق المقررات الرسمية من أجل تنمية ثقافة الطالب والارتقاء بحسه الفني وتعليمه مهنا يستفيد منها ماديا خلال عطلة المدارس الصيفية مثل الطباعة على الآلة الكاتبة التي كانت مطلوبة كثيرا في تلك الفترة من قبل البنوك والشركات. ولا أبالغ لو قلت أني عشت أجمل سنوات طفولتي وصباي في تلك الأجواء واستفدت منها كثيراً. أما المرحلة الثانوية فقد درستها في المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة بالخبر من عام 1967 إلى 1970 لعدم وجود ثانوية من بناء شركة أرامكو. وفي هذه المدرسة كانت الأجواء مختلفة وكنا نفتقد أشياء كثيرة تعودنا عليها، لكننا صبرنا وتكيفنا مع مرور الوقت، وخصوصاً مع سعادتنا بتعلم اللغة الفرنسية ضمن المنهج الرسمي على أيدي مدرسين من تونس. وأتذكر أني صممت وحررت آنذاك أول صحيفة حائط مدرسية باللغة الفرنسية التي عشقتها وواصلت تعلمها سنوات وأصبحت أجيدها إلى جانب العربية والإنجليزية والفارسية والهندية وشيء من الألمانية واليونانية والفنلندية.
 إذا ما انتقلنا إلى مرحلتك الجامعية، أين كانت؟ وما هي العقبات التي واجهتك خلالها؟- ترك لي والدي حرية اختيار المكان والتخصص، لكنه، وكان معذوراً في ذلك، لم يعد لي خطة مسبقة كما يفعل الآباء هذه الأيام مع أبنائهم، الأمر الذي تسبب لي في حيرة وإحباط. حيث راسلت عدة جامعات وكانت الردود بالاعتذار بسبب غلق باب القبول. وإزاء ذلك لم أجد مفراً من الالتحاق بكلية البترول والمعادن التي أمضيت بها سنة يتيمة كطالب تمهيدي من أجل إتقان اللغة الإنجليزية بطلاقة قبل دراسة الهندسة أو العلوم أو الرياضيات. وأتذكر أنها كانت سنة مملة وثقيلة؛ لأن الكلية كانت أشبه بالكليات العسكرية لجهة الصرامة في مواعيد النوم والوجبات والتريض والخروج. لكن ما أزعجتني أكثر وكان سبباً في عدم استمراري بالدراسة هو حظر التحدث بالعربية أو الاستماع إلى الإذاعات العربية أو قراءة المطبوعات العربية بحجة تعويد الطالب على الإنجليزية «لغة الدراسة والمناهج». بعدها أخذني والدي، الذي كان كثير التردد على الهند من أجل تجارته، إلى بومباي وأدخلني كلية «سانزيفيير» العريقة، وكنت قد استفدت كثيراً من دراستي للإنجليزية بكلية البترول والمعادن، فلم أمر فيها بالمرحلة التحضيرية. ولكن اندلاع حرب البنغال بين الهند وباكستان سنة 1971 دفعت الأسرة إلى استدعائي خوفاً على حياتي، وخصوصاً بعد أن انتشرت أخبار تفيد بقرب قيام الجيش الباكستاني بقصف مدينة بومباي. وهكذا تركت الدراسة هناك وقررت ألا أعود، وبدأت البحث هذه المرة عن دراسة الاقتصاد في بيروت التي حصلت فيها على درجة البكالوريوس سنة 1975.
إذا ما انتقلنا إلى مرحلتك الجامعية، أين كانت؟ وما هي العقبات التي واجهتك خلالها؟- ترك لي والدي حرية اختيار المكان والتخصص، لكنه، وكان معذوراً في ذلك، لم يعد لي خطة مسبقة كما يفعل الآباء هذه الأيام مع أبنائهم، الأمر الذي تسبب لي في حيرة وإحباط. حيث راسلت عدة جامعات وكانت الردود بالاعتذار بسبب غلق باب القبول. وإزاء ذلك لم أجد مفراً من الالتحاق بكلية البترول والمعادن التي أمضيت بها سنة يتيمة كطالب تمهيدي من أجل إتقان اللغة الإنجليزية بطلاقة قبل دراسة الهندسة أو العلوم أو الرياضيات. وأتذكر أنها كانت سنة مملة وثقيلة؛ لأن الكلية كانت أشبه بالكليات العسكرية لجهة الصرامة في مواعيد النوم والوجبات والتريض والخروج. لكن ما أزعجتني أكثر وكان سبباً في عدم استمراري بالدراسة هو حظر التحدث بالعربية أو الاستماع إلى الإذاعات العربية أو قراءة المطبوعات العربية بحجة تعويد الطالب على الإنجليزية «لغة الدراسة والمناهج». بعدها أخذني والدي، الذي كان كثير التردد على الهند من أجل تجارته، إلى بومباي وأدخلني كلية «سانزيفيير» العريقة، وكنت قد استفدت كثيراً من دراستي للإنجليزية بكلية البترول والمعادن، فلم أمر فيها بالمرحلة التحضيرية. ولكن اندلاع حرب البنغال بين الهند وباكستان سنة 1971 دفعت الأسرة إلى استدعائي خوفاً على حياتي، وخصوصاً بعد أن انتشرت أخبار تفيد بقرب قيام الجيش الباكستاني بقصف مدينة بومباي. وهكذا تركت الدراسة هناك وقررت ألا أعود، وبدأت البحث هذه المرة عن دراسة الاقتصاد في بيروت التي حصلت فيها على درجة البكالوريوس سنة 1975.
 لماذا اخترت لبنان؟- في الحقيقة كانت مصر هي الخيار الأول الذي فكرت فيه بعد عودتي من الهند، لكن أحوالها السياسية في تلك الفترة جعلتني أتردد. لذا كان لبنان هو الخيار البديل، وخصوصاً أن والدي شجعني عليه لأنه كان على علاقة ببعض العائلات اللبنانية، وطلب منهم تسهيل إقامتي ودراستي هناك مع توفير الرعاية والتوجيه. وهكذا كانت دراستي في لبنان خياراً صائباً، وعشت فيه أجمل فترات حياتي ونهلت من مناهله الجامعية والثقافية والفكرية والفنية والترفيهية ما لا أستطيع وصفه أو تعداده.فقد كان لبنان في تلك الفترة يوصف بسويسرا الشرق وكان يتيح لزواره والمقيمين فيه كل ما تشتهي الأنفس وعلى أعلى المستويات. وجملة القول أني استفدت من أجواء بيروت أضعاف ما استفدته من دراستي الجامعية، وعليه قررت أن أبقى في بيروت لمواصلة دراستي العليا، لولا اندلاع حربها الأهلية في صيف 1975، فخرجنا منها تحت قصف المدافع والصواريخ بعد أن بقينا فترة في الملاجئ. وكان خروجنا بمعجزة ربانية وتحت حراسة مليشيات حزبية كانت مسيطرة على مكان إقامتنا بمنطقة الحمراء، وبوساطة من سفير سلطنة عمان الشقيقة في بيروت آنذاك الشيخ عبدالله القتبي استجابة لطلب من زميلي العماني في السكن والدراسة المرحوم «موسى بن جعفر بن حسن» الذي صار لاحقاً سفيراً لبلاده لدى اليونيسكو ثم مستشاراً للمنظمة.
لماذا اخترت لبنان؟- في الحقيقة كانت مصر هي الخيار الأول الذي فكرت فيه بعد عودتي من الهند، لكن أحوالها السياسية في تلك الفترة جعلتني أتردد. لذا كان لبنان هو الخيار البديل، وخصوصاً أن والدي شجعني عليه لأنه كان على علاقة ببعض العائلات اللبنانية، وطلب منهم تسهيل إقامتي ودراستي هناك مع توفير الرعاية والتوجيه. وهكذا كانت دراستي في لبنان خياراً صائباً، وعشت فيه أجمل فترات حياتي ونهلت من مناهله الجامعية والثقافية والفكرية والفنية والترفيهية ما لا أستطيع وصفه أو تعداده.فقد كان لبنان في تلك الفترة يوصف بسويسرا الشرق وكان يتيح لزواره والمقيمين فيه كل ما تشتهي الأنفس وعلى أعلى المستويات. وجملة القول أني استفدت من أجواء بيروت أضعاف ما استفدته من دراستي الجامعية، وعليه قررت أن أبقى في بيروت لمواصلة دراستي العليا، لولا اندلاع حربها الأهلية في صيف 1975، فخرجنا منها تحت قصف المدافع والصواريخ بعد أن بقينا فترة في الملاجئ. وكان خروجنا بمعجزة ربانية وتحت حراسة مليشيات حزبية كانت مسيطرة على مكان إقامتنا بمنطقة الحمراء، وبوساطة من سفير سلطنة عمان الشقيقة في بيروت آنذاك الشيخ عبدالله القتبي استجابة لطلب من زميلي العماني في السكن والدراسة المرحوم «موسى بن جعفر بن حسن» الذي صار لاحقاً سفيراً لبلاده لدى اليونيسكو ثم مستشاراً للمنظمة.
 من بعد بيروت، أين كانت محطتك التالية؟- الصدفة وحدها جعلت محطتي التالية بعد بيروت هي القاهرة التي لم أكن قد زرتها من قبل، وملخص القصة هو أن المليشيات التي تولت نقلي مع زميلي إلى مطار بيروت، حذفتنا هناك قائلة: "دبروا حالكم يا شباب". وقتها كان المطار مزدحماً وكان هناك تدافع للخروج من لبنان بأي شكل، ولم يكن بالمطار سوى طائرة واحدة متجهة إلى القاهرة، فبذلنا المستحيل للصعود إليها إلى أن جاءت المساعدة من فتاة لبنانية من موظفات المطار كنا نعرفها من منطقة الحمراء، فسهلت أمورنا وطرنا إلى القاهرة ونحن نبكي على ما حل بلبنان على أيدي أهلها. في القاهرة سكنت مع طلبة عمانيين دارسين في شقة جميلة بمدينة الأطباء والصيادلة القريبة من نادي الصيد بالدقي. وقررت أن أواصل تعليمي لنيل درجة الماجستير بجامعة القاهرة، وساعدني في ترتيبات الالتحاق بها المرحوم الدكتور عمرو محي الدين (ابن عم زكريا محي الدين) الذي كان وقتها أستاذاً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أجمل ما في هذه المرحلة من حياتي هو أني كنت شاهداً على عصر التحولات من عهد الاشتراكية الناصرية إلى عهد الانفتاح والاقتصاد الحر الذي دشنه الرئيس السادات. كما أن إقامتي ودراستي بالقاهرة في هذه الفترة منحتني فرصة التجوال في مصر ورؤية معالمها وآثارها ومرابعها وكنوزها الثقافية والفنية وكل ما كنا نراه من مدهشات في أفلام الأبيض والأسود. وبإيجاز شديد كنت سعيداً في القاهرة لجهة المعيشة، وخصوصاً أن الأسعار والإيجارات والخدمات كانت منخفضة مقارنة مع بيروت. أما لجهة الدراسة فلم أكن سعيداً بسبب المنهج وطريقة التدريس وازدحام قاعات الدرس. لذا قررت بعد سنة يتيمة أن أنهي تجربتي الجميلة في مصر وأرحل إلى الولايات المتحدة لنيل الماجستير من هناك، واخترت لذلك مدينة بوسطن الجميلة الهادئة والبعيدة عن صخب نيويورك وكاليفورنيا، وجامعة بوسطن العريقة.وبطبيعة الحال، فقد بدأت هناك حياة مختلفة وواجهت عالماً آخر من كل النواحي وزاملت طلبة من كل الجنسيات، بل انتهزت الفرصة وتعلمت وتدربت على أشياء كنت أطمح أن أتعلمها في صغري. ولم يكن يؤرقني سوى غلاء المعيشة والبعد الجغرافي عن الأهل والأحباب والأصدقاء.وهكذا نلت ماجستير العلاقات الدولية وأتبعته بالحصول على دبلوم التخصص في الشؤون الآسيوية، وهذه إحدى ميزات الدراسة في أمريكا وهو إتاحة الفرصة لمن يريد من الطلبة التخصص، بل التدرب مع إحدى الجهات ذات العلاقة، والقيام ببحوث ميدانية في الخارج على نفقة تلك الجهات.
من بعد بيروت، أين كانت محطتك التالية؟- الصدفة وحدها جعلت محطتي التالية بعد بيروت هي القاهرة التي لم أكن قد زرتها من قبل، وملخص القصة هو أن المليشيات التي تولت نقلي مع زميلي إلى مطار بيروت، حذفتنا هناك قائلة: "دبروا حالكم يا شباب". وقتها كان المطار مزدحماً وكان هناك تدافع للخروج من لبنان بأي شكل، ولم يكن بالمطار سوى طائرة واحدة متجهة إلى القاهرة، فبذلنا المستحيل للصعود إليها إلى أن جاءت المساعدة من فتاة لبنانية من موظفات المطار كنا نعرفها من منطقة الحمراء، فسهلت أمورنا وطرنا إلى القاهرة ونحن نبكي على ما حل بلبنان على أيدي أهلها. في القاهرة سكنت مع طلبة عمانيين دارسين في شقة جميلة بمدينة الأطباء والصيادلة القريبة من نادي الصيد بالدقي. وقررت أن أواصل تعليمي لنيل درجة الماجستير بجامعة القاهرة، وساعدني في ترتيبات الالتحاق بها المرحوم الدكتور عمرو محي الدين (ابن عم زكريا محي الدين) الذي كان وقتها أستاذاً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أجمل ما في هذه المرحلة من حياتي هو أني كنت شاهداً على عصر التحولات من عهد الاشتراكية الناصرية إلى عهد الانفتاح والاقتصاد الحر الذي دشنه الرئيس السادات. كما أن إقامتي ودراستي بالقاهرة في هذه الفترة منحتني فرصة التجوال في مصر ورؤية معالمها وآثارها ومرابعها وكنوزها الثقافية والفنية وكل ما كنا نراه من مدهشات في أفلام الأبيض والأسود. وبإيجاز شديد كنت سعيداً في القاهرة لجهة المعيشة، وخصوصاً أن الأسعار والإيجارات والخدمات كانت منخفضة مقارنة مع بيروت. أما لجهة الدراسة فلم أكن سعيداً بسبب المنهج وطريقة التدريس وازدحام قاعات الدرس. لذا قررت بعد سنة يتيمة أن أنهي تجربتي الجميلة في مصر وأرحل إلى الولايات المتحدة لنيل الماجستير من هناك، واخترت لذلك مدينة بوسطن الجميلة الهادئة والبعيدة عن صخب نيويورك وكاليفورنيا، وجامعة بوسطن العريقة.وبطبيعة الحال، فقد بدأت هناك حياة مختلفة وواجهت عالماً آخر من كل النواحي وزاملت طلبة من كل الجنسيات، بل انتهزت الفرصة وتعلمت وتدربت على أشياء كنت أطمح أن أتعلمها في صغري. ولم يكن يؤرقني سوى غلاء المعيشة والبعد الجغرافي عن الأهل والأحباب والأصدقاء.وهكذا نلت ماجستير العلاقات الدولية وأتبعته بالحصول على دبلوم التخصص في الشؤون الآسيوية، وهذه إحدى ميزات الدراسة في أمريكا وهو إتاحة الفرصة لمن يريد من الطلبة التخصص، بل التدرب مع إحدى الجهات ذات العلاقة، والقيام ببحوث ميدانية في الخارج على نفقة تلك الجهات.
 يبدو أنك كنت سعيداً في بوسطن، فلما لم تواصل الدراسة فيها لنيل الدكتوراه؟- استمعت لنصيحة من المرحوم الدكتور غازي القصيبي بضرورة تنويع أماكن الدراسة من أجل الاطلاع على أنظمة الدراسة المختلفة والتشرب من ثقافات جديدة ومخالطة أناس جدد. ولهذا حزمت حقائبي بعد سنتين في بوسطن وغادرت إلى بريطانيا، حيث التحقت بجامعة إكستر في أقصى جنوب إنجلترا لبدء مرحلة الدكتوراه التي أخذت مني أربع سنوات متواصلة من البحث الشاق في المكتبات البريطانية بالطريقة اليدوية المنهكة (لم يكن النت قد انتشر بعد). وفي هذه المرحلة، ورغم الحياة الآمنة الجميلة في لندن التي أقمت فيها بشقة تواجه سفارة البحرين القديمة بمنطقة غلوستر زمن السفيرين كريم الشكر والشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، إلا أن ما كان يكدر حياتي هو غلاء المعيشة والإيجارات المرتفعة إلى درجة أني بحثت عن عمل في المكتبات ثم في الترجمة كي أحصل على ما يعينني على مصاريفي ونثرياتي اليومية على الأقل. كما أني عانيت وقتها من الإرهاق والضجر بسبب ندرة المراجع والمصادر اللازمة لتوثيق أطروحتي التي كانت غير مسبوقة وتتناول موضوع "أثر العامل الداخلي في صنع السياسات الخارجية".
يبدو أنك كنت سعيداً في بوسطن، فلما لم تواصل الدراسة فيها لنيل الدكتوراه؟- استمعت لنصيحة من المرحوم الدكتور غازي القصيبي بضرورة تنويع أماكن الدراسة من أجل الاطلاع على أنظمة الدراسة المختلفة والتشرب من ثقافات جديدة ومخالطة أناس جدد. ولهذا حزمت حقائبي بعد سنتين في بوسطن وغادرت إلى بريطانيا، حيث التحقت بجامعة إكستر في أقصى جنوب إنجلترا لبدء مرحلة الدكتوراه التي أخذت مني أربع سنوات متواصلة من البحث الشاق في المكتبات البريطانية بالطريقة اليدوية المنهكة (لم يكن النت قد انتشر بعد). وفي هذه المرحلة، ورغم الحياة الآمنة الجميلة في لندن التي أقمت فيها بشقة تواجه سفارة البحرين القديمة بمنطقة غلوستر زمن السفيرين كريم الشكر والشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، إلا أن ما كان يكدر حياتي هو غلاء المعيشة والإيجارات المرتفعة إلى درجة أني بحثت عن عمل في المكتبات ثم في الترجمة كي أحصل على ما يعينني على مصاريفي ونثرياتي اليومية على الأقل. كما أني عانيت وقتها من الإرهاق والضجر بسبب ندرة المراجع والمصادر اللازمة لتوثيق أطروحتي التي كانت غير مسبوقة وتتناول موضوع "أثر العامل الداخلي في صنع السياسات الخارجية".
 هل واصلت الدكتوراه مباشرة بعد حصولك على الماجستير أم عملت في إحدى الوظائف؟- مرحلة الدكتوراه جاءت بعد عدة سنوات من حصولي على الماجستير ودبلوم التخصص، والسبب أني كنت في حاجة إلى مال كي أنفق به على مرحلة الدكتوراه. ولهذا قررت العودة إلى الخبر للالتحاق بأعمال الوالد وتطويرها نظير راتب شهري، وخصوصاً أنه كان قد هرم ولم يعد باستطاعته العمل بمفرده كما الماضي. وقد وجدت في ذلك واجباً تجاه والدي الذي أفنى حياته في تربيتنا، ورداً لجميله في الإنفاق على تعليمي الجامعي في بومباي وبيروت والقاهرة. وبعد مدة، ورغم الخبرات التي راكمتها من التعامل مع شركات ومصانع أجنبية كثيرة في أوروبا وآسيا، وجدت أني لم أخلق للعمل التجاري وأن علي مواصلة دراستي كي أحقق طموحاً كان يداعب خيالي منذ صغري وهو نيل الدكتوراه، ففعلت وأنجزت أطروحتي، بالرغم من تشدد الإنجليز في كل كبيرة وصغيرة وقسوتهم في جلسات الاستماع والمناقشة. بعدها قررت العودة للبقاء إلى جانب والدي ووالدتي في شيخوختهما، لأفاجأ بأن الوالد يصفي أعماله استعداداً للانتقال إلى البحرين كي يعيش بها بقية عمره، فانضممت إليه وأنا سعيد بعودتنا واستقرارنا أخيراً في البحرين، التي لم ينقطع عنها أبداً.
هل واصلت الدكتوراه مباشرة بعد حصولك على الماجستير أم عملت في إحدى الوظائف؟- مرحلة الدكتوراه جاءت بعد عدة سنوات من حصولي على الماجستير ودبلوم التخصص، والسبب أني كنت في حاجة إلى مال كي أنفق به على مرحلة الدكتوراه. ولهذا قررت العودة إلى الخبر للالتحاق بأعمال الوالد وتطويرها نظير راتب شهري، وخصوصاً أنه كان قد هرم ولم يعد باستطاعته العمل بمفرده كما الماضي. وقد وجدت في ذلك واجباً تجاه والدي الذي أفنى حياته في تربيتنا، ورداً لجميله في الإنفاق على تعليمي الجامعي في بومباي وبيروت والقاهرة. وبعد مدة، ورغم الخبرات التي راكمتها من التعامل مع شركات ومصانع أجنبية كثيرة في أوروبا وآسيا، وجدت أني لم أخلق للعمل التجاري وأن علي مواصلة دراستي كي أحقق طموحاً كان يداعب خيالي منذ صغري وهو نيل الدكتوراه، ففعلت وأنجزت أطروحتي، بالرغم من تشدد الإنجليز في كل كبيرة وصغيرة وقسوتهم في جلسات الاستماع والمناقشة. بعدها قررت العودة للبقاء إلى جانب والدي ووالدتي في شيخوختهما، لأفاجأ بأن الوالد يصفي أعماله استعداداً للانتقال إلى البحرين كي يعيش بها بقية عمره، فانضممت إليه وأنا سعيد بعودتنا واستقرارنا أخيراً في البحرين، التي لم ينقطع عنها أبداً.
 وكيف بدأ عملك الصحفي؟- الانشغال بالعمل ككاتب صحفي وليس كصحفي هو هواية بدأت من تصميم وإعداد وتحرير صحف الحائط المدرسية زمن تعليمي النظامي، وخصوصا أني كنت متميزاً في الرسم والخط. وخلال مرحلة دراستي في بيروت بهرتني حياتها الصحفية وتعدد صحفها وحريتها في النشر والانتقاد، فقررت أن أشارك بمقال بعثته إلى جريدة النهار مذيلا بعبارة "عبدالله المدني - طالب جامعي"، لكن مرت أسابيع طويلة من دون أن أراه منشوراً حتى فقدت الأمل، وحينما حكيت القصة لأحد الزملاء ضحك ملء شدقيه وقال لي: "من أنت حتى تنشر لك كبرى صحف لبنان مقالاً؟. واقترح عليك أن أبعث المقال إلى جريدة "الأنوار" وأن أذيله بعبارة "د. عبدالله المدني - باحث في الاقتصاد السياسي"، ففعلت وتم نشر المقال في غضون أيام. ومنذ يومها عرفت أن حرف الدال له وقع ساحر في المجتمع العربي.بعد ذلك تعددت كتاباتي الصحفية وتعددت معها مواقع النشر، وهو ما ساهم، مع الممارسة والاطلاع، في تحسين قدراتي اللغوية والنحوية، حيث أني كنت من طلبة القسم العلمي ممن لم يدرسوا النحو والبلاغة والأدب بتعمق في المرحلة الثانوية. وإبان دراستي في بريطانيا كتبت لصحيفة الحياة التي خصصت لي زاوية أسبوعية بمساعدة كاتبها ومحررها المتميز المسؤول الأستاذ حازم صاغية الذي لفت انتباهه مقال مطول من جزءين بعنوان "بيروت ما بعد الحرب بعيون خليجية" كنت قد كتبته في أعقاب عودتي إلى بيروت بعد غياب 18 سنة لتفقد مواطن ذكرياتنا الطلابية وما حل بها من دمار. كما كتبت مقالات في الشأن الآسيوي فقط في صحيفة القدس العربي فترة قصيرة، علاوةً على ذلك كنت أراسل من لندن عبر الفاكس صحيفة أخبار الخليج في البحرين وصحيفة الخليج في الشارقة وصحيفة الوطن في السعودية وصحيفة "غلف نيوز" الإنجليزية في دبي. وكانت هذه الكتابات تدر على مبالغ تافهة كنت أصرفها على الشاي والقهوة والمواصلات واقتناء الكتب والمجلات والتردد على صالات السينما.ومن تجاربي الصحفية التي استمرت عدة سنوات تجربتي مع صحيفة أخبار الخليج زمن رئيس تحريرها الراحل هلال الشايجي ومدير تحريرها أحمد عبدالغني رحمهما الله، فمن خلالها بدأ اسمي يلمع ككاتب سياسي متخصص. لكن بسبب بعض الخلافات في الرأي وحول المكافآت، تركت الصحيفة واستوطنت جريدة "الأيام" منذ التسعينات وسط ترحيب ودعم من الأستاذ نبيل الحمر والأخ الأستاذ عيسى الشايجي والمرحوم الأستاذ سعيد الحمد رحمه الله. ومنذ ذلك التاريخ لم أترك الأيام، على الرغم من عروض استكتاب جاءتني من صحف بحرينية أخرى ومعها منصب دائم في الصحيفة براتب مقطوع، لأني وجدت أن الاستجابة لتلك العروض فيها نوع من قلة الوفاء للأيام التي لم تتعرض لمقالاتي يوماً بالحذف أو الشطب، بل خصصت لي في السنوات الأخيرة صفحة أسبوعية كاملة لنشر ما أكتبه في التاريخ الاجتماعي لمنطقة الخليج، علاوةً على مقالين أسبوعيين آخرين، أحدهما في الشأن الآسيوي والآخر في الفن.بمناسبة مقالاتك في الأيام، نجدك تجتهد في حقول تاريخية وفنية ليست من ضمن تخصصك الأكاديمي؟ فما هو السر في هذا التدفق وهذه الانشغالات؟أؤمن بالتخصص، لذا أتناول الشأن الآسيوي أسبوعياً بتعمق، لأن ذلك من ضمن تخصصي الذي أعرف فيه ما لا يعرفه الآخرون، ولا سيما أني أعرف آسيا ميدانيا ومطلع على ثقافات شعوبها وسياسات حكومتها وأنظمة حكمها وتاريخها، لكن هذا لا يمنع من الكتابة في مجالات أخرى بحكم الهواية، فإحدى هواياتي البحث والتنقيب في التاريخ الاجتماعي لدول الخليج الست، وخصوصا أن التاريخ الاجتماعي أهمل طويلاً ولم ينل نصيبه من الاهتمام كالتاريخ السياسي والأدبي. ومن جهة أخرى أهوى كل ما يتعلق بالفنون غناء وموسيقى وأفلاما ومسرحيات منذ أن كنت طفلا أجلس متسمرا أمام شاشة تلفزيون أرامكو من الظهران لأتابع الأفلام المصرية وأدون أسماء أبطالها ونجماتها ومخرجيها في كراسة صغيرة، ناهيك عما أصابنا في تلك الفترة من هوس بنجوم الشاشة المصرية وحرصنا على شراء مجلة الكواكب المصرية وجمع أفيشات الأفلام من المجلات وتبويبها وتبادلها كما في حالة طوابع البريد.
وكيف بدأ عملك الصحفي؟- الانشغال بالعمل ككاتب صحفي وليس كصحفي هو هواية بدأت من تصميم وإعداد وتحرير صحف الحائط المدرسية زمن تعليمي النظامي، وخصوصا أني كنت متميزاً في الرسم والخط. وخلال مرحلة دراستي في بيروت بهرتني حياتها الصحفية وتعدد صحفها وحريتها في النشر والانتقاد، فقررت أن أشارك بمقال بعثته إلى جريدة النهار مذيلا بعبارة "عبدالله المدني - طالب جامعي"، لكن مرت أسابيع طويلة من دون أن أراه منشوراً حتى فقدت الأمل، وحينما حكيت القصة لأحد الزملاء ضحك ملء شدقيه وقال لي: "من أنت حتى تنشر لك كبرى صحف لبنان مقالاً؟. واقترح عليك أن أبعث المقال إلى جريدة "الأنوار" وأن أذيله بعبارة "د. عبدالله المدني - باحث في الاقتصاد السياسي"، ففعلت وتم نشر المقال في غضون أيام. ومنذ يومها عرفت أن حرف الدال له وقع ساحر في المجتمع العربي.بعد ذلك تعددت كتاباتي الصحفية وتعددت معها مواقع النشر، وهو ما ساهم، مع الممارسة والاطلاع، في تحسين قدراتي اللغوية والنحوية، حيث أني كنت من طلبة القسم العلمي ممن لم يدرسوا النحو والبلاغة والأدب بتعمق في المرحلة الثانوية. وإبان دراستي في بريطانيا كتبت لصحيفة الحياة التي خصصت لي زاوية أسبوعية بمساعدة كاتبها ومحررها المتميز المسؤول الأستاذ حازم صاغية الذي لفت انتباهه مقال مطول من جزءين بعنوان "بيروت ما بعد الحرب بعيون خليجية" كنت قد كتبته في أعقاب عودتي إلى بيروت بعد غياب 18 سنة لتفقد مواطن ذكرياتنا الطلابية وما حل بها من دمار. كما كتبت مقالات في الشأن الآسيوي فقط في صحيفة القدس العربي فترة قصيرة، علاوةً على ذلك كنت أراسل من لندن عبر الفاكس صحيفة أخبار الخليج في البحرين وصحيفة الخليج في الشارقة وصحيفة الوطن في السعودية وصحيفة "غلف نيوز" الإنجليزية في دبي. وكانت هذه الكتابات تدر على مبالغ تافهة كنت أصرفها على الشاي والقهوة والمواصلات واقتناء الكتب والمجلات والتردد على صالات السينما.ومن تجاربي الصحفية التي استمرت عدة سنوات تجربتي مع صحيفة أخبار الخليج زمن رئيس تحريرها الراحل هلال الشايجي ومدير تحريرها أحمد عبدالغني رحمهما الله، فمن خلالها بدأ اسمي يلمع ككاتب سياسي متخصص. لكن بسبب بعض الخلافات في الرأي وحول المكافآت، تركت الصحيفة واستوطنت جريدة "الأيام" منذ التسعينات وسط ترحيب ودعم من الأستاذ نبيل الحمر والأخ الأستاذ عيسى الشايجي والمرحوم الأستاذ سعيد الحمد رحمه الله. ومنذ ذلك التاريخ لم أترك الأيام، على الرغم من عروض استكتاب جاءتني من صحف بحرينية أخرى ومعها منصب دائم في الصحيفة براتب مقطوع، لأني وجدت أن الاستجابة لتلك العروض فيها نوع من قلة الوفاء للأيام التي لم تتعرض لمقالاتي يوماً بالحذف أو الشطب، بل خصصت لي في السنوات الأخيرة صفحة أسبوعية كاملة لنشر ما أكتبه في التاريخ الاجتماعي لمنطقة الخليج، علاوةً على مقالين أسبوعيين آخرين، أحدهما في الشأن الآسيوي والآخر في الفن.بمناسبة مقالاتك في الأيام، نجدك تجتهد في حقول تاريخية وفنية ليست من ضمن تخصصك الأكاديمي؟ فما هو السر في هذا التدفق وهذه الانشغالات؟أؤمن بالتخصص، لذا أتناول الشأن الآسيوي أسبوعياً بتعمق، لأن ذلك من ضمن تخصصي الذي أعرف فيه ما لا يعرفه الآخرون، ولا سيما أني أعرف آسيا ميدانيا ومطلع على ثقافات شعوبها وسياسات حكومتها وأنظمة حكمها وتاريخها، لكن هذا لا يمنع من الكتابة في مجالات أخرى بحكم الهواية، فإحدى هواياتي البحث والتنقيب في التاريخ الاجتماعي لدول الخليج الست، وخصوصا أن التاريخ الاجتماعي أهمل طويلاً ولم ينل نصيبه من الاهتمام كالتاريخ السياسي والأدبي. ومن جهة أخرى أهوى كل ما يتعلق بالفنون غناء وموسيقى وأفلاما ومسرحيات منذ أن كنت طفلا أجلس متسمرا أمام شاشة تلفزيون أرامكو من الظهران لأتابع الأفلام المصرية وأدون أسماء أبطالها ونجماتها ومخرجيها في كراسة صغيرة، ناهيك عما أصابنا في تلك الفترة من هوس بنجوم الشاشة المصرية وحرصنا على شراء مجلة الكواكب المصرية وجمع أفيشات الأفلام من المجلات وتبويبها وتبادلها كما في حالة طوابع البريد.
 هل حصلت على جوائز صحفية أو شهادات تقدير بسبب أعمالك الصحفية؟- أفتخر أني أول بحريني يحصل على جائزة منتدى الإعلام العربي السنوي في دبي، وكان ذلك في عام 2015 عن أفضل مقال سياسي نشر في عام 2014، حيث نجحت في اصطياد الجائزة وسط تنافس محموم من مئات من الصحفيين العرب المدعومين من مؤسساتهم الصحفية. كما يكفيني فخراً أن رجل أعمال معروفاً كالوجيه الإماراتي العم خلف أحمد حبتور، استرعت كتاباتي التاريخية انتباهه فعرض مشكوراً طباعة بعض مؤلفاتي على نفقته الخاصة، وكان أول الغيث كتاب "رائدات ومبدعات من نساء الخليج" الذي صدر العام الماضي.لماذا لا تكتب مذكراتك، ولا سيما أن سيرتك مكتنزة بأشياء وحكايات كثيرة؟- من يكون عبدالله المدني حتى يكتب مذكراته؟ ومن يا ترى سوف يهتم بها؟ المذكرات الشخصية يكتبها عادة صناع القرار ورجالات الدولة والوجهاء ومن في حكمهم من الشخصيات التي لها بصمات خالدة في تاريخ أوطانها أو على شعوبها. أما أنا فمازلت أعتبر نفسي مجرد طالب في محراب العلم لم يؤت من المعارف سوى القليل.بلاحظ أنك لم تتول أي وظيفة رسمية طيلة حياتك، لماذا؟- لم يعرض علي في شبابي أي وظيفة أخدم بها بلدي، وخصوصا أني أمضيت الجل الأعظم من حياتي منشغلاً بطلب العلم خارج البحرين. ومن ناحية أخرى فضلت منذ البدايات أن أكون طليقاً ومتحرراً من أعباء وقيود الوظائف والمناصب كي أعيش حياتي على سجيتي. وأعتقد أني لو كنت قيدت نفسي بمسؤوليات الوظيفة لما استطعت أن أحقق حلما ظل يراودني منذ أن درست مادة الجغرافيا في المرحلة الابتدائية، وهو الطواف حول العالم وزيارة أكبر عدد من الدول والمدن. وقد وفقني الله بمجهودي الشخصي أن أحقق ذلك الحلم، فحتى العام الماضي كنت قد زرت 150 مدينة في 77 دولة في قارات العالم، علماً أني ضمنت مشاهداتي وما تعرضت له من مواقف وطرائف في كتاب قديم صدر عام 1990. وقد اتخذ أحد طلاب الماجستير في كلية الآداب بجامعة الملك سعود من هذا الكتاب مادة للحصول على درجته العلمية.وعلى الرغم من كل هذا، فقد عملت فترة وجيزة محاضراً ومعداً لورش العمل في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الإماراتية في أبوظبي، كما استعانت بي وزارة الخارجية البحرينية زمن وزيرها السابق الصديق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لإنجاز بعض المهام، إذ أرسلني معاليه إلى الكويت للإعداد للقمة العربية الآسيوية، وكلفني بالذهاب إلى نيودلهي للإعداد لأول مؤتمر عقد في البحرين بين وزيرة خارجية الهند ووزراء الخارجية العرب. إلى ذلك كلفتني وزارة الثقافة البحرينية زمن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتمثيل البحرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ألقيت محاضرة عن دور مصر الثقافي في البحرين، وأيضاً تمثيل البحرين في معرض الرياض الدولي للكتاب سنة 2019 حيث ألقيت محاضرة عن أسبقية البحرين وريادتها على المستوى الخليجي في كثير من مناحي الحياة، علما أن البحرين كانت ضيفة الشرف في كلتا المناسبتين. ومن جهة أخرى تمّ تكليفي من قبل وزارة الإعلام في الإمارات بتمثيلها في المعرض الدولي للكتاب في لندن لإلقاء محاضرة عن العلاقات الهندية الخليجية بمناسبة الاحتفاء بالهند في هذا المعرض كضيفة شرف.حدثنا عن حياتك العائلية- تزوجت متأخراً رغم إلحاح الوالدين علي بالزواج بعد الثانوية مباشرة. كنت ضد مبدأ الزواج المبكر ولا أزال لأنه يعيق المرء عن مراكمة التجارب والتحليق في الفضاءات المختلفة. لكن الرغبة في إنجاب الأولاد والشعور بالوحدة دفعاني للزواج في سن الخامسة والأربعين من سيدة أجنبية فاضلة تحملت كل أعباء الأسرة بمفردها كي تعفيني من الانشغال عن أعمالي البحثية والكتابية. وقد أنجبت لي طفلين هما: "تيمور" الذي لم يجد وظيفة تناسبه في البحرين فقرر أن يرحل إلى بوسطن للتحضير لرسالة الماجستير بعد أن تخرج قبل عدة سنوات من جامعة دبلن بأيرلندا حاملا بكالوريوس القانون وإدارة الأعمال. وشقيقته "في" التي ستتخرج هذا العام من كلية ترينتي بدبلن. آمل أن يكون حظهما في هذه الدنيا أفضل من والدهما.
هل حصلت على جوائز صحفية أو شهادات تقدير بسبب أعمالك الصحفية؟- أفتخر أني أول بحريني يحصل على جائزة منتدى الإعلام العربي السنوي في دبي، وكان ذلك في عام 2015 عن أفضل مقال سياسي نشر في عام 2014، حيث نجحت في اصطياد الجائزة وسط تنافس محموم من مئات من الصحفيين العرب المدعومين من مؤسساتهم الصحفية. كما يكفيني فخراً أن رجل أعمال معروفاً كالوجيه الإماراتي العم خلف أحمد حبتور، استرعت كتاباتي التاريخية انتباهه فعرض مشكوراً طباعة بعض مؤلفاتي على نفقته الخاصة، وكان أول الغيث كتاب "رائدات ومبدعات من نساء الخليج" الذي صدر العام الماضي.لماذا لا تكتب مذكراتك، ولا سيما أن سيرتك مكتنزة بأشياء وحكايات كثيرة؟- من يكون عبدالله المدني حتى يكتب مذكراته؟ ومن يا ترى سوف يهتم بها؟ المذكرات الشخصية يكتبها عادة صناع القرار ورجالات الدولة والوجهاء ومن في حكمهم من الشخصيات التي لها بصمات خالدة في تاريخ أوطانها أو على شعوبها. أما أنا فمازلت أعتبر نفسي مجرد طالب في محراب العلم لم يؤت من المعارف سوى القليل.بلاحظ أنك لم تتول أي وظيفة رسمية طيلة حياتك، لماذا؟- لم يعرض علي في شبابي أي وظيفة أخدم بها بلدي، وخصوصا أني أمضيت الجل الأعظم من حياتي منشغلاً بطلب العلم خارج البحرين. ومن ناحية أخرى فضلت منذ البدايات أن أكون طليقاً ومتحرراً من أعباء وقيود الوظائف والمناصب كي أعيش حياتي على سجيتي. وأعتقد أني لو كنت قيدت نفسي بمسؤوليات الوظيفة لما استطعت أن أحقق حلما ظل يراودني منذ أن درست مادة الجغرافيا في المرحلة الابتدائية، وهو الطواف حول العالم وزيارة أكبر عدد من الدول والمدن. وقد وفقني الله بمجهودي الشخصي أن أحقق ذلك الحلم، فحتى العام الماضي كنت قد زرت 150 مدينة في 77 دولة في قارات العالم، علماً أني ضمنت مشاهداتي وما تعرضت له من مواقف وطرائف في كتاب قديم صدر عام 1990. وقد اتخذ أحد طلاب الماجستير في كلية الآداب بجامعة الملك سعود من هذا الكتاب مادة للحصول على درجته العلمية.وعلى الرغم من كل هذا، فقد عملت فترة وجيزة محاضراً ومعداً لورش العمل في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الإماراتية في أبوظبي، كما استعانت بي وزارة الخارجية البحرينية زمن وزيرها السابق الصديق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لإنجاز بعض المهام، إذ أرسلني معاليه إلى الكويت للإعداد للقمة العربية الآسيوية، وكلفني بالذهاب إلى نيودلهي للإعداد لأول مؤتمر عقد في البحرين بين وزيرة خارجية الهند ووزراء الخارجية العرب. إلى ذلك كلفتني وزارة الثقافة البحرينية زمن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتمثيل البحرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ألقيت محاضرة عن دور مصر الثقافي في البحرين، وأيضاً تمثيل البحرين في معرض الرياض الدولي للكتاب سنة 2019 حيث ألقيت محاضرة عن أسبقية البحرين وريادتها على المستوى الخليجي في كثير من مناحي الحياة، علما أن البحرين كانت ضيفة الشرف في كلتا المناسبتين. ومن جهة أخرى تمّ تكليفي من قبل وزارة الإعلام في الإمارات بتمثيلها في المعرض الدولي للكتاب في لندن لإلقاء محاضرة عن العلاقات الهندية الخليجية بمناسبة الاحتفاء بالهند في هذا المعرض كضيفة شرف.حدثنا عن حياتك العائلية- تزوجت متأخراً رغم إلحاح الوالدين علي بالزواج بعد الثانوية مباشرة. كنت ضد مبدأ الزواج المبكر ولا أزال لأنه يعيق المرء عن مراكمة التجارب والتحليق في الفضاءات المختلفة. لكن الرغبة في إنجاب الأولاد والشعور بالوحدة دفعاني للزواج في سن الخامسة والأربعين من سيدة أجنبية فاضلة تحملت كل أعباء الأسرة بمفردها كي تعفيني من الانشغال عن أعمالي البحثية والكتابية. وقد أنجبت لي طفلين هما: "تيمور" الذي لم يجد وظيفة تناسبه في البحرين فقرر أن يرحل إلى بوسطن للتحضير لرسالة الماجستير بعد أن تخرج قبل عدة سنوات من جامعة دبلن بأيرلندا حاملا بكالوريوس القانون وإدارة الأعمال. وشقيقته "في" التي ستتخرج هذا العام من كلية ترينتي بدبلن. آمل أن يكون حظهما في هذه الدنيا أفضل من والدهما.

 بحكم كونك كاتباً، ألم تواجه مشاكل وصعوبات مع الأشخاص؟- من البديهي أن الكثيرين لا تعجبهم مقالاتي، ولكن الناس تقرأ مقالاتي وتهتم بها وتنشرها، وخاصة بعدما حولت بعض كتاباتي في التاريخ الاجتماعي إلى برنامج تلفزيوني، تلبية لطلب من وزير الإعلام السابق الأستاذ علي محمد الرميحي، حيث أعددت 300 حلقة لم ينفذ منها سوى 36 حلقة بسبب الميزانية كما قيل لي.أحيانا تأتيني اتصالات للشكر على ما أنشر من كتابات عن السير الذاتية للشخصيات الخليجية، سواء من الشخصيات نفسها إن كانت على قيد الحياة أو من ورتها وأسرها. وأحيانا يبعثون إلي رسائل وباقات ورد أو هدايا عينية من دون أن أطلبها كنوع من التقدير. مقابل هذا تأتيني اتصالات مزعجة من أشخاص تشتم بدلا من أن تشكر، معترضة على تفاصيل صغيرة وهامشية في المادة. فالناس بعد ذلك معادن ومشارب، وكل يعمل بأصله وتربيته.أما في الكتابات السياسية فبعض الصحف تنشر المقال كاملاً من غير حذف أو تدخل، وبعضها تغير العنوان فقط، والبعض الثالث يعتذر عن نشر المقال ويطلب مقالاً بديلا، بحجة أنه قد يؤثر على العلاقات البينية مع دولة ما، وهكذا.ما هي نصيحتك للشباب؟- القراءة، ثم القراءة ثم القراءة، وتحديدا القراءة الجادة مع الاستيعاب في أي مجال وبأي لغة. فالقراءة هي التي تفتح النوافذ وتكسب المهارات وتنمي الأذهان وتشرع الأبواع نحو آفاق المعرفة. لولا القراءة معطوفا على الراديو ثم التلفزيون في زمننا الخمسيني لما نشأ الجيل الذهبي الذي تحدثنا عنه مجبولا على الارتقاء بالذات والخوض في مختلف الميادين بشجاعة وعصامية فريدة.نصيحة أخرى: أحبوا وطنكم، وأخلصوا له، وابذلوا كل ما تستطيعون للارتقاء به، ولا تنتظروا أن يقدم لكم مكافأة، فهذا واجبكم. وواصلوا تعليمكم إلى أقصى المراحل الممكنة، فهذا أيضا واجبكم تجاه مجتمعاتكم وأوطانكم قبل أن يكون هدفاً للارتقاء بذواتكم.عشت أشهرا في اليابان، وعرفت أن سر تفوقهم هو حرصهم على التعليم الحديث المتوافق مع متطلبات العصر، بل التفوق فيه أيضاً من منطلق أن ذلك واجب مقدس تجاه الوطن والإمبراطور والأسرة والمجتمع. أي بخلاف ما يحدث عندنا من تشجيع الأبناء على التعليم بهدف الحصول على وظيفة تدر دخلاً يمكنهم من الزواج والإنجاب والتملك وشراء الكماليات كالسيارة مثلا. كذلك لاحظت أن نجاح العملية التربوية والتعليمية عندهم مرتبط بإيلائهم أهمية خاصة بالمعلم والمبالغة في احترامه وتقديره والاحتفاء به وكأنه من القديسين، كونه أس العملية كلها.
بحكم كونك كاتباً، ألم تواجه مشاكل وصعوبات مع الأشخاص؟- من البديهي أن الكثيرين لا تعجبهم مقالاتي، ولكن الناس تقرأ مقالاتي وتهتم بها وتنشرها، وخاصة بعدما حولت بعض كتاباتي في التاريخ الاجتماعي إلى برنامج تلفزيوني، تلبية لطلب من وزير الإعلام السابق الأستاذ علي محمد الرميحي، حيث أعددت 300 حلقة لم ينفذ منها سوى 36 حلقة بسبب الميزانية كما قيل لي.أحيانا تأتيني اتصالات للشكر على ما أنشر من كتابات عن السير الذاتية للشخصيات الخليجية، سواء من الشخصيات نفسها إن كانت على قيد الحياة أو من ورتها وأسرها. وأحيانا يبعثون إلي رسائل وباقات ورد أو هدايا عينية من دون أن أطلبها كنوع من التقدير. مقابل هذا تأتيني اتصالات مزعجة من أشخاص تشتم بدلا من أن تشكر، معترضة على تفاصيل صغيرة وهامشية في المادة. فالناس بعد ذلك معادن ومشارب، وكل يعمل بأصله وتربيته.أما في الكتابات السياسية فبعض الصحف تنشر المقال كاملاً من غير حذف أو تدخل، وبعضها تغير العنوان فقط، والبعض الثالث يعتذر عن نشر المقال ويطلب مقالاً بديلا، بحجة أنه قد يؤثر على العلاقات البينية مع دولة ما، وهكذا.ما هي نصيحتك للشباب؟- القراءة، ثم القراءة ثم القراءة، وتحديدا القراءة الجادة مع الاستيعاب في أي مجال وبأي لغة. فالقراءة هي التي تفتح النوافذ وتكسب المهارات وتنمي الأذهان وتشرع الأبواع نحو آفاق المعرفة. لولا القراءة معطوفا على الراديو ثم التلفزيون في زمننا الخمسيني لما نشأ الجيل الذهبي الذي تحدثنا عنه مجبولا على الارتقاء بالذات والخوض في مختلف الميادين بشجاعة وعصامية فريدة.نصيحة أخرى: أحبوا وطنكم، وأخلصوا له، وابذلوا كل ما تستطيعون للارتقاء به، ولا تنتظروا أن يقدم لكم مكافأة، فهذا واجبكم. وواصلوا تعليمكم إلى أقصى المراحل الممكنة، فهذا أيضا واجبكم تجاه مجتمعاتكم وأوطانكم قبل أن يكون هدفاً للارتقاء بذواتكم.عشت أشهرا في اليابان، وعرفت أن سر تفوقهم هو حرصهم على التعليم الحديث المتوافق مع متطلبات العصر، بل التفوق فيه أيضاً من منطلق أن ذلك واجب مقدس تجاه الوطن والإمبراطور والأسرة والمجتمع. أي بخلاف ما يحدث عندنا من تشجيع الأبناء على التعليم بهدف الحصول على وظيفة تدر دخلاً يمكنهم من الزواج والإنجاب والتملك وشراء الكماليات كالسيارة مثلا. كذلك لاحظت أن نجاح العملية التربوية والتعليمية عندهم مرتبط بإيلائهم أهمية خاصة بالمعلم والمبالغة في احترامه وتقديره والاحتفاء به وكأنه من القديسين، كونه أس العملية كلها.
{{ article.visit_count }}

WhatsApp Image 2023-04-04 at 3.05.48 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.44.24 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.34.26 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.22.30 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.40.44 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.29.00 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.49.25 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.24.47 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.31.06 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 3.05.48 PM

WhatsApp Image 2023-04-04 at 2.39.41 PM